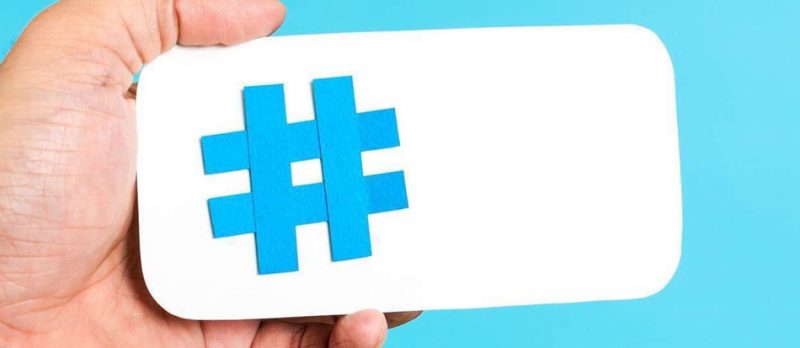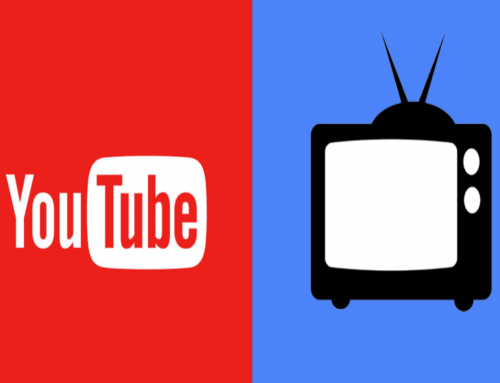رغم أن عبارة “حرب الهاشتاقات” غير مستعملة حسب البحث على “جوجل”، إلا أن معظم قراء المقال يدركون ما هي، فهي جزء من استهلاكنا اليومي للمعلومات على تويتر، بل إن أحد الكلمات الشائعة على “تويتر” هي أن يتم “هشتقة” شخص معين، وكأنك سجنته بين خطوط رمز الهاشتاق (#) وجهزته لتلقي كل أنواع الضربات التي لا تعرف الرحمة، بل تستمتع بفكرة الهجوم الساحق على الشخص “المهشتق”.
في الفترة الماضية، بدأت تنتشر نوع آخر من “الهشتقة” وهي خلق هاشتاق مضاد لهاشتاق آخر، ويتحزب الجمهور في فسطاطين، أحدهما يدعم أحد الهاشتاقات والآخر يدعم الثاني، ويمكن طبعا متابعة الإحصاءات لترى أيهما يتقدم أكثر، بل إن موقعا مثل hashtagbattle.com يقدم لك بشكل سريع مثل هذا الإحصاء الذي يقارن هاشتاقين ضد بعضهما.
حرب الهاشتاقات هي ظاهرة أخرى من ظواهر هذه الإمكانيات الجبارة للشبكات الاجتماعية التي تسمح بأن يجتمع ملايين الأشخاص في مكان افتراضي واحد ليناقشوا موضوعا واحدا وكأننا جميعا نعيش في غرفة واحدة، ولكن في نفس الوقت كلنا يملك المناعة التي تسمح لنا بالتخفي أو الهجوم الذي لا يعرف خجلا أو خوفا.
هذا يشرح حجم التحزبات الموجودة على شبكة “تويتر” بما جعل الشبكة الاجتماعية تتحول من أداة لتوحيد نسيج المجتمع –كما كان متوقعا نظريا من العالم الافتراضي- إلى أداة للتقسيم والصراع و”الحرب” أحيانا.
ولكن في رأيي ليست هذه المشكلة الوحيدة هنا، فالهاشتاقات تعني تسطيح القضايا بشكل مخيف، وتحويلها إلى أبيض وأسود، دون الاعتراف بالأبعاد الرمادية العديدة لأي قضية، ودون الاعتراف بأن النقد الصادق يعني النظر للجوانب الإيجابية والسلبية في شخص ما، ومحاولة الالتزام بشيء من الموضوعية في التعامل مع الموضوعات بأنواعها.
الهاشتاقات أيضا تعني أن نحاول اختصار الآراء بكلمات قليلة تنسى كل التفاصيل والأعماق العديدة لأي قضية، وتحولها إلى كلمة نعم أو لا.

إن التفكير النقدي واحد من أهم ما يميز المجتمعات المدنية والحضارات، وإذا كانت مناهج التعليم العربية قد قصرت بشكل هائل في تعليم الطلبة طرق التفكير النقدي (مقارنة بالمناهج الغربية ومقارنة بتاريخ التعليم الإسلامي الذي كان يركز على المنطق والفلسفة)، فإن ما يحدث على “تويتر” يعني تراجعا أكبر وسطحية غير مألوفة، وهي تزداد بسرعة تثير الكثير من القلق لأي شخص يهمه مستقبلنا الثقافي والفكري.
عندما ظهرت شبكة الإنترنت، كان الفلاسفة الاجتماعيون يقولون بأن مشكلة الشبكة أنها ستسمح لعامة الناس غير المثقفين أن يدخلوا في حوار على أرضية واحدة مع المثقف، وهذا يعني أن يهبط المثقف إلى غير المثقف أو العكس، ولكن ما هو ملحوظ في مجتمعاتنا أن المثقف والأكاديمي والرجل ذي الخبرة قد هبط فعلا إلى أرضية أكثر سطحية وأقل عمقا، وهو هبوط مبرر لأنه يعني المزيد من المتابعين (الفلورز) والريتويت والتفاعل وزيادة القوة عندما تبدأ حرب الهاشتاقات.
قبل أسابيع كتبت هنا مقالا عن الإيجابية على الشبكات الاجتماعية وقيمتها الوطنية، وجاء منتدى “مدونون سعوديون” في الرياض بعدها ليؤكد على تلك القيم، وكانت هذه نقلة هامة، وهي إيجاد عمل مؤسساتي يهدف لتطوير المجتمع فيما يتعلق بتعامله مع الشبكات الاجتماعية.
قضية السطحية وحرب الهاشتاقات واستقطاب المجتمع وشقه إلى نصفين حول الفكرة الواحدة، هي قضايا تحتاج أيضا إلى معالجة، ومعالجتها جزء من الإيجابية، والحل دائما يبدأ من مناهج التعليم لجيل جديد يصعد حاليا دون أن يكون هناك أي تعليم لما ينبغي فعله على الشبكات الاجتماعية والتي يقضي كثير من الشباب حوالي 25% من ساعات فراغه في المعدل وهو يقتات عليها.
إن مراقبة “تويتر” واستخدام الأدوات الإحصائية لها دور هام في فهم المجتمع وتحليله بشكل عام، ولكنها أيضا تسمح بمراقبة تطور المجتمع، لأن الشبكات الاجتماعية ليست مجرد مرآة لنا، بل هي عامل شديد التأثير في حياتنا وقيمنا وأخلاقنا وطريقة تعاملنا مع القضايا والناس، فلا شيء يؤثر في الإنسان مثل ضغط الرأي العام.
إهمال ذلك يعني أن نشاهد مجتمعاتنا وعموم الناس تتغير للأسوأ ولحد أقل من الموضوعية ومقدار أكبر بكثير من التفكير ذي البعد الواحد دون بذل أي وسائل للعلاج.
كيف يمكن أن تكتب رأيا منصفا ودقيقا وموضوعيا في 140 حرفا ؟
لا أحد عنده الجواب الكافي، فهذه مشكلة “تويتر” الأصيلة، وهي سبب انتشاره أيضا، لكن هذا لا يعني أيضا الاستسلام، وإطلاق الآراء على عواهنها بدون أدلة وبدون تمهل لأجل كسب الأتباع وتسديد الأهداف في حروب الهاشتاقات.
في الماضي كنا نقول: “تويتر” فضح عوراتنا، واليوم يمكننا القول بأن “تويتر” يخلق المزيد من العيوب والمشكلات والعورات.
* نشر المقال في جريدة الوطن السعودية