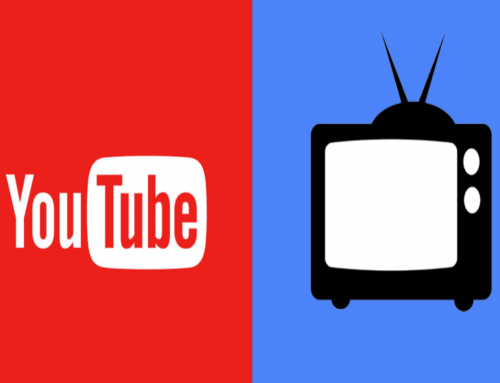الحرية الشخصية بالنسبة للغربيين ليست مجرد خيار سياسي أو اجتماعي، بل هي عقيدة وفلسفة تقوم عليها الحضارة الغربية، ويؤمن بها الغربيون كأساس تقوم عليها جزئيات حياتهم، ومستعدون للتضحية بالكثير من المبادئ الأخرى من أجل هذه العقيدة.
في العالم العربي، يختلف الأمر، فالحرية الشخصية كانت لعقود طويلة مجرد حل مطروح ضمن خيارات نظرية متعددة لعلاج المشكلات الضخمة التي يعاني منها، وهناك نسبة عالية من الجمهور مستعدة للتضحية بهذا الخيار إذا كانت الحياة ستمضي على ما يرام من الناحية الاقتصادية.
هذا ما حاولت شرحه في مقال الأسبوع الماضي بشكل عام؛ كان هذا حتى جاء الإنترنت.
كان الحلم الذي صحا عليه فجأة كل عشاق “حرية التعبير” بمختلف فلسفاتها، بالنسبة لهم، الإنترنت هو “عالم افتراضي” جديد له قوانينه الخاصة التي لا علاقة لها بقوانين البشر في العالم الحقيقي.
في الإنترنت لا توجد حدود ولا قوانين ولا حكومة مركزية ولا قيود على من يشارك، بل إن الإنترنت تجاوز بالناس حدودا لم يكن يحلمون بتجاوزها حتى في أكثر الدول ديمقراطية، ففي السابق كنت تحتاج أن تتجاوز الحارس القاسي متجهم الوجه الواقف على بوابات وسائل الإعلام لتستطيع المشاركة والتعبير عن رأيك للجماهير.
اليوم، وفي أي مكان في العالم، وبأي لغة، وبالمجان، وفي وقت قصير، وبانتشار يتجاوز وسائل الإعلام تستطيع أن تقول أي شيء تريده.
أليست هذه الحقيقة التي تشبه الأحلام ولم تخطر ببال أكثر الروائيين خيالا ؟
لم يخف على الحكومات والمؤسسات الأمنية حول العالم منذ أن ظهر الإنترنت ماذا يعني ذلك، وكانت هناك محاولات عديدة لتغيير الواقع الذي جاء مفاجئا، وتحرك بسرعة هائلة، وتحت حماية القوة الأكبر، أمريكا، التي رأت في التسعينات الميلادية، أن هذه الحرية ستسمح لشبكة الإنترنت بأن تملك أمريكا قوة ثقافية واستراتيجية أكبر في مختلف دول العالم، وهو ما تحقق فعلا بلا شك.
لكن هذا الإنجاز لم يتحقق بسهولة حتى داخل أمريكا.
لقد دخل أنصار “حرية التعبير” في الغرب معركة كانوا يعرفون أنها ستكون عنيفة، وأن المؤسسات التشريعية في مختلف أنحاء العالم سرعان ما ستحكم قبضتها على شبكة الإنترنت وتبدأ بإصدار القوانين التي تحدد أنشطتها، لذلك استنفر هؤلاء كل قواهم للدفاع عن ما يسمى بـ”الحرية الرقمية” Digital Freedom.
أخذ الدفاع عن الحرية الرقمية أشكالا متعددة بذل فيها جهود ضخمة، وكان أول إنجاز حققه هؤلاء هو كسب الشركات المزودة لخدمة الإنترنت وعلى رأسها ميكروسوفت وأمريكا أون لاين ثم جوجل وفيسبوك وغيرها إلى جانبهم.
لقد اقتنع الرأسماليون الكبار في أمريكا وعلى رأسهم بيل جيتس، أن الحرية الرقمية تعني نشاطا أكبر لشبكة الإنترنت وآفاقا أوسع وأن الحدود والقوانين ستقلل من نشاط الإنترنت وستسحب البساط من تحت أقدام شركات الإنترنت لتضعها سجادا أحمر تحت أقدام الموظفين البيروقراطيين.
هذه القناعة جعلت شركات الإنترنت تقرر الممانعة ضد أي طلبات حكومية أو شعبية أو سياسية بإزالة مواقع معينة مهما كان خطورة المحتوى، حتى لو كان شرحا لكيفية صنع قنبلة أو استهزاء بكل القيم في العالم أو حتى لو كانت مذكرات قاتل شهير في أمريكا يحكي فيها من موقعه الذي صممه في السجن الفدرالي الأمريكي حكاياته مع ضحاياه من النساء الذين يتجاوزون الستين ويحكي كيف كان يتلذذ باغتصاب هؤلاء النساء وقتلهن وتقطيعهن كما كان يحكي كيفية النجاة من القانون والشرطة “وهو الموقع الذي رفضت شركة جيوسيتيز قبل حوالي 10 سنوات إزالته إبان الضغط الذي قام به أهالي هؤلاء الضحايا والجمعيات الأخلاقية”، كل ذلك كان يتم باسم “حرية التعبير”.
من الأساليب الأخرى التي تم اتباعها لكسب معركة “الحرية الرقمية” تأسيس الجمعيات الخيرية الضخمة المتخصصة في الدفاع عن الحرية الرقمية وتنظيم حملات ضخمة مستمرة لـ”ضمان حرية التعبير على الإنترنت”، ونجحت تلك الحملات في إيقاف قانون يستهدف ممارسة نظام إغلاق المواقع في خدمات الإنترنت في المدارس والمكتبات، كما نجحوا في إجبار بعض الجامعات الأمريكية التي تمارس نظام إغلاق المواقع اللا أخلاقية على التراجع عن ذلك، ونجحوا في أن يضعوا على أجندة الرئيس الأمريكي ووزارة الخارجية حماية حرية مواقع الإنترنت في كل دول العالم.
كل هذه الإنجازات تراجعت كثيرا في السنوات الست الأخيرة لأسباب عديدة، بسببها صار ينطبق على الحرية الرقمية المثل الشهير: ما زاد على حده انقلب إلى ضده، وهو ما سأتحدث عنه في الأسبوع القادم.