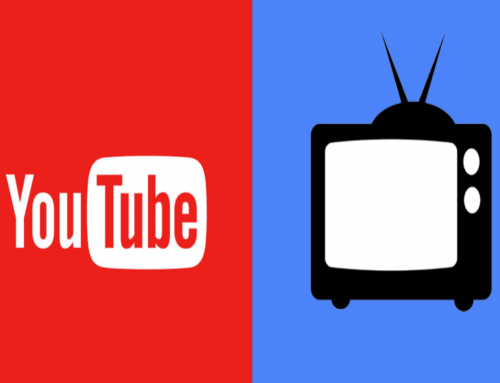ليس غريبًا أن تكون أبعاد مصطع «الثقافة الشعبية» أو «الثقافة الشائعة» Popular Culture، في العالم العربي جديدة على القارئ، فثقافتنا العربية منذ من طويل جدا ثقافة «النخبة» و«المرجعية» Authority، وليست ثقافة العامة والفوغاء.
وإذا كان أفلاطون قد طالب بسيطرة العلماء والحكماء والنبلاء على مدينتة الفاضبلة، وطالب بتهميش العامة واستعبادهم، فنحن بعض من طبق الفلسفة اليونانية على المستوى الاجتماعي والفكري والديني والسياسي والثقافي والإعلامي؛ وكان هذا التطبيق شأن جميع الشعوب حتى جاءت الفلسفة الديمقراطية/الرأسمالية/الفردية لتنادي بسيادة الأغلبية؛ والأغلبية دائمًا في كل زمن من الأزمنة وكل مجتمع من المجتمعات هم »الشعب» أو «العامة».
لكن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرًا سريعا جدًا في الغالم العربي، تغيرًا يسحب البساط بشكل مفاجئ لصالع العموم على حساب النخبة، وهذا التغير حصل على كل المستويات، والسبب هو التكنولوجيا والاتصالات بالدرجة الأولى، وانهيارنا السياسي والفكري والاجتماعي والاقتصادي، وانحدار التعليم وفشل الخطاب الديني المعاصر بالدرجة الثانية.
فعلى المستوى الثقافي، بدات النخبة التي سيطرت على وسائل التعبير وكراسي التلقين فترة طويلة من الزمن تسمع بمنافسة الفرد العادي «الجاهل» الذي صار يتصل ببرنامج تلفزيوني أو إذاعي يسمعه الملايين ليقول ما يريد أو يذهب للإنترنت ليدعي ما يريد. وبدات نظم الانتخابات تغزونا بضفوط داخلية وخارجية ليرى رجل النخبة نفسه مضطرًا إلى الاستماع والحديث لـ«رجل الشارع».
وعلى المستوى الإعلامي. صارت عبارات «النزول لمستوى الشارع»، و«المادة الخفيفة» و«اللمسة الشبابية» وصفات سحرية ينطق بها كل من يريد إنقاذ وسيلة إعلامية من الغرق, ليتخلى الإعلام عن تقاليده وينطلق باحثًا عن رغبات «العامة» وشهواتهم لعله يكسب رضاهم وجيويهم.
دينيًا، ورغم الحث الشرعي المكثف على احترام العلماء وأتباعهم، بدأ ذلك يتلاشى تدريجيا، حتى صار العلماء ذوو المصداقية في العالم الإسلامي أقل من اصابع اليد الواحدة،وصار كل من يمكنه إصدار شريط «كاسيت» أو كتيب أو المشاركة العاطفية في أحد المنتديات قائدًا دينيا، بل صار الناس، كل الناس، يفتون ويصدرون آراء دينية جرينة دون أي خجل.
أما على المستوى السياسي فتحدث عن أزمة تعانيها كل الأنظمة السياسية عرييًا؛ والتي وجدت نفسها في محاولة لمواجهة «من يفهم ومن لا يفهم» ممن يركيون صهوة الإنترنت والفضائيات وحتى رسائل الجوال ليعلنوا عن آرائهم السياسية، حتى اتسع
الخرق على الراقع، وصار العديث عن المشاركة السياسية أمرًا مملًا لأنه حديث كل يوم لكل «فرد».
اجتماعيا، «كان» الأب ذا تقدير واحترام، و«كان» الأخ الكبير له رأيه، و«كان» لكل قبيلة شيخها، و«كان» لكل آسرة كبيرها، و«كان» للزوج قوامته.
أما الآن فالنزّعة الفردية تنخر في بنائنا الاجتماعى بسرعة مذهلة، ويتحرك الكثيرون من فتات المجتمع «الشعبية» عن «حقوقهم» الضائعة في زمن سيطرة النخية.
أما النخبة الثقافية، وهي أعرق سلالات النخب على الإطلاق تاريخيًا، فهي لم تضمحل من الوجود بعد، ولكتها تصارع ذلك، أمام حقيقة أن كل من ظهرت صورته في الجريدة وقال شينًا ذا معنى، وكل من اقترب من «الشعب» وحفظوا اسمه لسيب أو لآخر صار مثقفًا يستشار في عظائم الأمور قبل صغارها.
ولعل الكثير من القراء “انطلافًا من الثقافة العربية التي ترفض الموضوعية” يبحث عني بين السطور، هل أنا مع الشعب أم مع النخبة ويماذا أنادي.
والجواب، إن الصراع بين النخية والشعب هو حقيقة قديمة، وتفوق الشعب في القرن الحادي والعشرين هو واقع علينا أن نتعامل به قبلنا أم رفضنا مع اليقين أن الحق كان في كثير من الأحيان مع النخبة وكان في أحيان كثيرة مع الشعب لكن هذا لا يغير من الأمر شيئا.
إن تجاهل النخبة لـ«الشارع» ورفضهم له خوفًا من الطوفان الجارف خطأ فادح، لأن العوامل التي ساههت في الظاهرة في طريقها للنمو “التكنولوجيا والانهيار العام”.
ولذا فإن على النخبة أن تغرف «حدودها» الجديدة وتلزم دوائر التأثير الخاصة بهاء وتترك الجماهيرية والحظ و«السوير ستار» للشعب، وعلى «النخبة» أن تعرف مسؤوليتها الجديدة وهي دراسة هذه الظواهر ومتابعة تفاضيلها ودراسة طرق التحكم فيها
إيجابيًا، وإلا صارت كل وسائل إعلامنا مكونة من أغان في غاية السقم ونساء يتمايلن بكل الطرق، ولصارت منابرنا الدينية ملكًا لمن يختطفها لـ«مصلحته»، ولعمت الفوضي، وتهدمت الأسرة، وصارت العناوين الرئيسة في صحفنا عن «الرجل الذي عض كلبا» وأخبار «السوير ستار».
لماذا نفعل ذلك؟
هذه الوصفة ليست وصفة سحرية، بل هي قريبة مما يحصل في الحضارة الغربية، والفرق بيننا وبينهم، أن مراكز دراسات «الثقافة الشعبية» لديهم تبيع هذه المعلومات للشركات، وللمرشحين السياسيين، ولتجار الأفكار الذين يؤقلمون خطابهم على أساسها، ” وهذا لا يشمل طبعا الطبقة الرفيعة من الأكاديميين والمثقفين الغربيين الذين يبحثون عن سبل الإصلاح والإنقاذ”.
كما أن الفرق هو أن مفكري «الثقافة الشعبية»، يؤمنون بهذه الثقافة كثقافة بديلة Alternative Culture، بينما نحن ندرس هذه الثقافة لأنها في بلادنا «الضعيفة حضاريًا» ستكون تابعة للثقافة الغربية التي تملك كل وسائل التأثير «الشعبية» “الأفلام السينمائية، التلفزيون،. الإنترنت، الأغاني، الأزياء، النجوم، الثقافة الاجتماعية.. إلخ”، أو ستكون تابعة للجهلة والمغرضين ودعاة العنف والجشعين، وهي بذلك ستكون دائمًا عامل تدمير لا بناء. هذا طبعا إلا إذا..
إلا إذا ماذا؟
من المؤكد أنه يمكن تمامًا «هندسة الثقافة الشعبية» والتحكم فيها وتوجيهها وتحويلها لعامل بناء بدلاً من أن تكون عامل هدم، ولنا في سيرة رسول الله، والخلفاء من بعده أسوة، كما أن لنا في بعض تجارب الثقافة الغربية والقوانين العلمية الاجتماعية عبرة ودروسًا يمكن استقاء الحلول منها، ومن يدري فقد تتحول الجموع العربية من «غثاء كغثاء السيل» إلى عامل بناء شامل وسريع بعد أن فشلت النخبة في معالجة المشكلات المعقدة التي تحيط بنا من كل جائب، وتطبق علينا كما تطبق الأكلة على قصعتها.
ومهما تكاثرت الحلول وتباينت وجهات النظر، فإننا _ في رأيي _ يجب أن نرفض تمامًا أي حل يرتبط بالضغط على الثقافة الشائعة ضغطًا قسريًا، وهذا لثلاثة أسباب:
- أن التجارب المعاصرة في بلادئا وفي الغرب تثبت أن الضغط على الثقافة الشعبية لا يلغيها بل يدفعها للتخفي لتتحول «لثقافة تحت الأرض» Underground Culture، وهذا أخطر أنواع الثقافة الشعبية وأكثرها تدميرًا، لأنها بعيدة عن كل توجيه، وملك لقيادة الشخصيات المؤثرة شديدة السلبية والرفض للمجتمع، ولأنها قد تتجمع شيئًا فشيئًا حتى تنفجر وتفسد في الأرض ويصبح من المستحيل محاصرتها أو التحكم فيها، فضلاً عن إصلاحها.
- الضغط على الثقافة الشعبية في أيامنا هذه صار شيئًا غير ممكن على الإطلاق، لأن التكنولوجيا تجاوزت كل الأبواب وكل الحراس، ولأن أكثر الناس صاروا الآن جزءًا من الثقافة الشعبية، والمواجهة تعني وضع عود في وجه الطوفان.
- عندما تتحدث دراسات «هندسة الثقافة الشعبية» عن التأثير، فهي تتحدث دائمًا عن التغلغل في وسط دوائر الثقافة الشعبية وتحويلها إيجابيًا من الداخل، تمامًا كما يتم تغبير الجينات وهندستها وراثيا وليس أبدًا من خلال محاربتها أو السعى للسيطرة عليها أو استمالتها من الخارج.
ما الحل إذن ؟
في هذه العجالة «النخبوية» ألخص أهم الأفكار في مجال هندسة الثقافة الشعبية:
- مراعاة التنوع: الثقافة الشعبية ليست ثقافة واحدة، بل هي مئات من دوائر الثقافات، تتقاطع بعضها مع بعض وتنتشر بطول وعرض «المساحة الشعبية»، بعض هذه الدوائر سطحي، وبعضها عميق، وبعضها سخيف، وبعضها مرعب، وبعضها كبير، وبعضها صغير جذا، ويعضها رفيع تلاشى كالضباب، وبعضها سميك محافظ على بقائه، وبعضها واضح كوضوح الشمس، وبعضها خفي جدًا.
والتعامل مع هذه الدوائر بطريقة واحدة دلالة جهل، ولا بد من بناء استراتيجيات متنوعة بتنوع هذه الدوائر، وبتنوع الصفات الديمغرافية للأشخاص الذين ينتمون إلى هذة الدوائر.
- مراعاة الصقات المشتركة: ليس هناك خط رفيع يفصل بين النخبة والعامة، فالكثير ممن يظهرون على أنهم نخبويون ينتمون إلى تيارات الثقافة الشعبية في حياتهم الخاصة/ والكثير من العامة سواء كانوا متعلمين أو قراء، مستعدون لدخول عالم النخبوية متى أتيحت لهم الفرصة.
هؤلاء الذين يقفون في الوسط على الجدار الفاصل بين النخبة والعامة هم الطبقة التي يمكنها تقديم الحل، وتؤمن التقارب وتسمح بتبادل التأثير.
- تحويل دوائر الثقافة الشعبية إلى مؤسسسات: قد يحتاج شرح هذا العامل إلى مئات الصفحات، وقد شرح فعلاً في
كتب أمريكية وفرنسية مطولة، وقد يختلف الكثيرون في صحته، لكن الدراسات تنادى دائما بالسماح لدوائر الثقافة الشعبية للتحول إلى مؤسسات وجمعيات ومجموعات أنشطة.
إن التجارب تثبت أن التعامل مع المؤسسة أسهل من التعامل مع الأفراد، والتعامل مع المؤسسة يمكن من إصلاحها ويصلح بذلك معظم أعضاء المؤسسة المخلصين، بينما التعامل مع القرد صعب ومضيع للوقت أكثر من ذلك، فقد أثبتت كثير من التجارب التي ركزت على إصلاح مجموعات الثقافة الشعيية السلبية مثل المجموعات العنصرية، أن تحويل هذه المجموعات إلى مؤسسات يضعها في الضوء الذي يضطرها إلى تبرير فلسفتها، والدفاع عنها والرد على حجج الرافضين لها، وهذا يؤدى في الغالب إلى سيطرة العناصر الجيدة وموت العناصر البكتيرية في ضوء الشمس وفتح أبواب المؤسسة للإصلاح.
وعلى كل حال، فإن أي متخصص في الثقافة الشعبية لن يرضى بإمكانية إصلاح «الشعب» أو «العامة» ما لم تكن لهم أنشطة ثقافية واجتماعية وفكرية بأشكال عديدة تنهك القوى السلبية وتستهلك القوى الحائرة وتترك للقوى الإيجابية عجلة القيادة.
- استخداع وسائل الثقافة الشعبية: تعتبر التجرية الأمريكية من التجارب الناجحة غالميًا في عصرنا الحديث في استخدام وسائل الثقافة الشعبية للتاثير في الثقافة الشعبية نفسها، فـ«هوليوود» بكل سلبياتها تم الاستفادة مثها في كثير من الأحيان لبث رسائل نخبوية داخلية وخارجية وكانت مؤثرة لحد كبير.
كما استخدم الأمريكيون الإنترنت بشكل مذهل في نشر رسائلهم حول العالم، واستخدموا النجوم والشعارات الشعبية لنشر الثقافة الأمريكية حول العالم.
إنني لا أفهم بأي شكل من الأشكال كيف تتشدق التيارات النخبوية الإيجابية بالرغبة في إصلاح العموم وهي لا تملك قناة فضائية ناجحة، تاركة الميدان للمتردية والنطيحة وما أكل «السبع»، وكيف تدعي الإصلاح وهي لا تملك مجلة مقروءة شعبيًا ولا جريدة يومية، ولا «نظريات شعبية»، ولا حتى تواصلا معقولا مع الدوائر الشعبية “أستثني من ذلك شريط الكاسيت الذي استخدم في بعض الأحيان إيجابيًا”.
إن هذا حاصل في كثير من الأحيان لأن التخبة لا ترى إلا النخب، وتظن أن وسائل التأثير النخبوية ستصل إلى العامة، أو أن عصا سحرية ستلامس العامة فتحولهم إلى مستهلكين للوسائل النخبوية.
- دراسة الثقافة الشعبية: دعونا هذه المرة نقف ونرفض أي جهود ليست قائمة على تخطيط ولا دراسات، دزاسة الثقافة الشعبية من خلال مراكز أبحاث منظمة أمر لا مهرب منه إذا كنا نريد ولو لمرة واحدة «هندسة الثقافة الشعبية».
أقسام الجامعات الأكاديمية من خلال أقسام الإعلام والاجتماع واللغة وغيرها، يمكنها أن تساهم بشكل هائل في هذا الدور.
أيضا نحتاج مجلات متخصصة في الثقافة الشعبية، وهذه ليست من المجلات التافه والسخيفة التي تمتلئ بها مكتباتنا، بل من نوع المجلات الذي يقدم تقارير صحفية ودراسات جادة عن الظواهر الشعبية على تنوعها، ويترك للجميع _ نخبة وعامة _ فرصة
المشاركة في تفسير وتحليل هذه الظواهر.
- التعليم الراقي والتربية الصارمة: تتمييز التجربة الآسيوية بأنها تعاملت مع خوفها من الثقافات الغريية من خلال نشر روح الجدية في أبنائها ورفع مستوى نظم التعليم إلى حدود نسمع عنها ولا نصدقها، واستقادت من ذلك في بناء حضارة سريعة النمو وواسعة التأثير.
التعليم الراقي جدًا والتربية الصارمة القائمة على المبادئ التي ترتفع بالذات وليست القائمة على الضغط والاضطهاد، هما في رأيي الشخصي الحل الذي يمكن أن تنطلق منه الأمة العربية والإسلامية في استغلال جموع الثقافة الشعبية لتتحول إلى جموع منتجة ذكية جادة تنطلق بمسيرة البناء والتحدي وترفعنا من وحل الحضيض.
المشكلة الأساسية في هذا الحل هي أن مؤسسات التعليم الراقي لن يبنيها إلا «النخبة» الذين يؤمئون بهذا الحل ويضحون بالغالي والنفيس لتحقيقه، ويضعون صراعاتهم جانبا ولا تغمض عيونهم أجفائها بسلام حتى يسلموا الرايات لمن يقود المسيرة من بعدهم، لو رأيت هؤلاء فقبل رؤوسهم.
- الأطفال هم الحل: موضوع الأطفال العرب وما يلاقونه من ازدراء نخبوي عام موضوع كتبت فيه مئات الصفحات وآكل الزمان عليه وشرب، ولا يختاج لتكرار، فالحقيقة الثابتة الباقية هي أن الأطفال العرب يكبرون دون نظرة رحمة أو عطف ثقافي.
الأطفال هم نواة الجيل القادم، والعناية بهم يعني العناية بالبذور بدلاً من إصلاح الأشجار الفاسدة.
- فتش عن المرأة: الكثيرون يظنون أن عملية الإصلاح يمكن أن تكتمل دون المرأة، وهؤلاء سواء كانوا من الغربيين أو الآسيويين أو العرب كما تشير التجارب العالمية، فشلوا لأنهم تجاهلوا عنصرًا رهيبًا في تأثيره القوي والخفي في الوقت نفسه.
المرأة في عالمنا العربي لا تنتمي إلى النخبة إلا نادرًا، ولا تلقى من نصيب المشاركة الثقافية إلا النزر اليسير، وإن كانت دائمًا هي من تربي وتشارك النخبة حياتهم في بيوتهم، وتجاهلها أدى في كثير من الأحيان _ بما في ذلك التجربة الأمريكية الشهيرة في الستينيات المبلادية وتجريتنا العربية الحالية _ تجاهلها أدى إلى نتائج وخيمة يندم الجميع عليها رجالاً ونساء.
إن لنا في الإسلام ما يكفي ليشرح لنا كيف يمكن إصلاح جماهير النساء، هذا طبعًا شريطة أن تعامل المرأة كـ«إنسان».
- المصالح العامة: تشير الدراسات إلى أن خير أسلوب للتاثير في عموم الناس هو المصالح العامة، وخير طريقة للحديث عن المصالح هي الطريقة العاطفية، وهذة قاعدة عامة للسياسيين والمفكرين والمصلحين وحتى رجال الأعمال.
إنني دائمًا أعجب عندما أقرأ عن هذا من عظمة النص القرآني الذي لم ينس مصالح الناس الدنيوية ومصالحهم الأخروية “الترغيب في جنان الخلد”، واستخدام الأسلوب العاطفي والعقلي في الوقت نفسه، بحيث يبقى هذا النص العظيم معجزا في تأثيره وعظمته.
واخيرًا..
أرجو أن تكون السطور السابقة مقدمة لكتابة أعمق عن «الثقافة الشعبية»، إذ لم أرد حشو هذه السطور بالنظريات وتفاصيل التجارب العالمية، والحجج المنطقية، وإنما هو استعراض سريع للبؤر المركزية في فهم الثقافة الشعبية.
ولعل فيها ما يوحي بإجابات لأسئلة «المعرفة» عن ثقافة الشارع وعن السلام والعنف، كما أرجو أن يكون فيها تذكرة لمن «يحلم» يومًا بعالم عربي «أجمل».
* نُشر في مجلة المعرفة السعودية