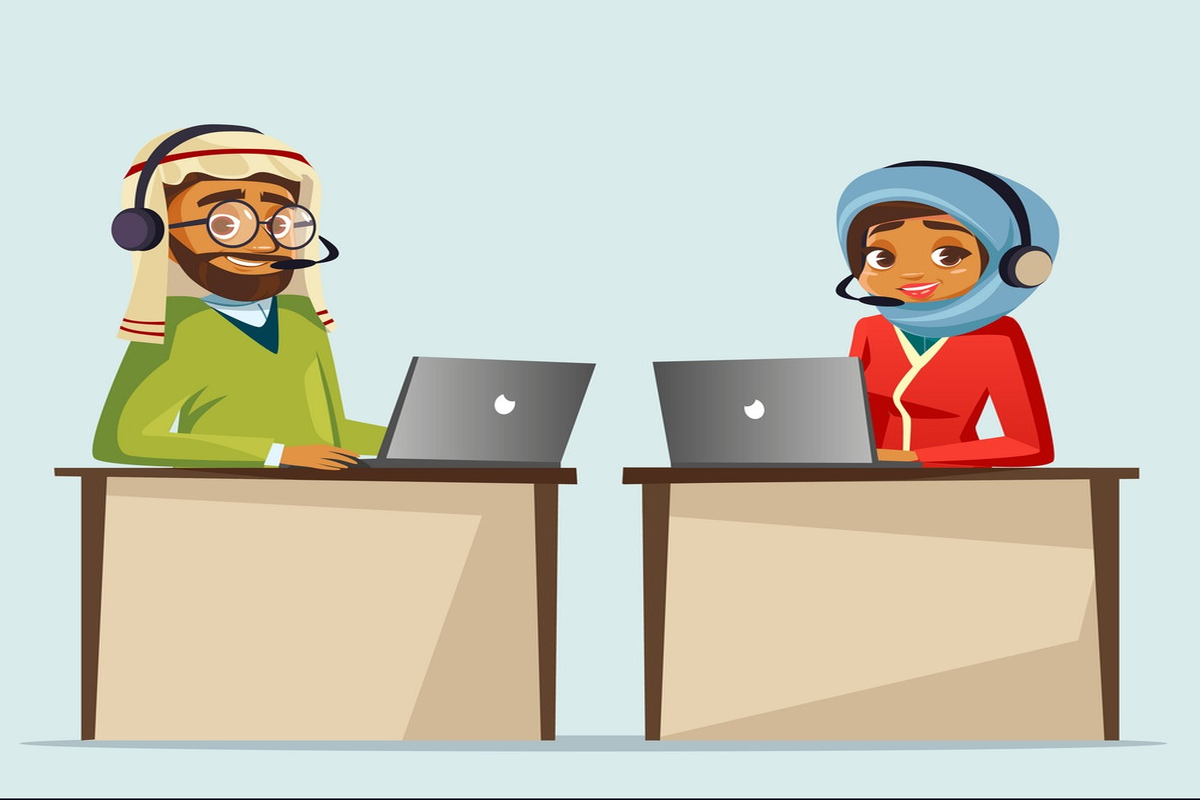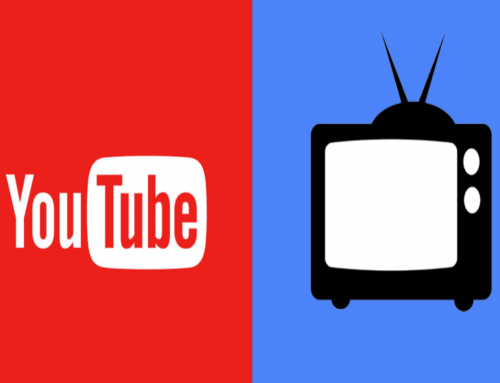من أسباب تحريم الغناء كما ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، الخوف أن يبرر الاستماع للغناء حب المغنين والفنانين والموسيقيين، وغالبهم من السطحيين و”التافهين” والعصاة، وتفضيلهم على العلماء وأصحاب الرأي والأدب والعلم، فيصبحوا بذلك قدوة يحتذى بها.
والحقيقة أنك سواء استمعت للغناء أو لم تستمع، فوسائل الإعلام ممتلئة حتى آخر نقطة حبر بأخبار الفنانين والفنانات على اختلاف ألوانهم، وصار الشاب المسلم يعرف عن أخبار “مشاجرة” شخصية بين فنانة وأخرى، بينما يتردد كثيرا قبل أن يقرر فيما إذا كان أحد العلماء الكبار حيا أو ميتا.
أحد الأسباب التي قد يحسن التنبه إليها أن الإعلام بطبيعته يبحث عن الناس التي بطبيعتها تحب المشهورين وتتابع أخبارهم، ورغم أن الكثير من أصحاب العلم والأكاديميين والأدباء من المشاهير إلا أن القليل منهم جدا من يتفهم الدور الإعلامي الخطير للأخبار البسيطة التي تتناول حياتهم وآرائهم والمشاريع القادمة التي يعملون عليها، ويتفهمون أهمية الاستجابة للإعلاميين وعدم “تطفيشهم” كلما اقتربوا على بعد 100 متر منهم.
الشهرة ارتبطت في ثقافتنا بالرياء وحب الظهور، ولكنها تحولت في عصرنا الحاضر إلى أداة إعلامية لا يستغني عنها من يرغب في التأثير في عموم الناس وكسب قلوبهم، وهذا ما يفرض علينا أن “نتسامح” مع شخصيات الأمة إذا “تنازلوا” لمتطلبات المشاركة في العمل الإعلامي، وهذا ما يجعلنا ننظر بعين التقدير لجهود شخصيات تعاملت بتفهم مع إعلام القنوات الفضائية مثل د . طارق السويدان، والشيخ جاسم المطوع، والشيخ عائض القرني، وغيرهم.
سيبقى الفنانون والفنانات نجوما ساطعة إعلاميا لأن أحدا غيرهم لا يقبل الإسفاف والتصنع وتقبيل أرجل الجماهير والظهور في “كل” مجلة وجريدة وقناة بمناسبة وبدون مناسبة، ولكن في نفس الوقت على الجميع، الإعلاميون والنخبة في المجتمع، التأمل من جديد في استخدام الإعلام لصناعة القادة و”النجوم الحقيقيين” بدلا من ترك الساحة “لهم ولهن”.
حملة جوية على «أسامة بن لادن» في عام 2008
في الأسابيع الأولى من الحملات الجوية العسكرية الأمريكية على أفغانستان، توقع اللواء والمفكر الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي، في منتداه الثقافي الأسبوعي، أن يبقى أسامة بن لادن، حرا طليقا دون أن تمسه أيدي القوات الأمريكية وحلفائهم الأفغانيين.
بنى الدكتور عشقي، توقعه هذا _ والذي نشره مفصلا في مقال نشر حينها في جريدة عكاظ _ على سلوك سياسي أمريكي يقتضي إبقاء أعدائها كـ”مسمار جحا” الذي تستخدمه كلما اقتضى الأمر بما يحقق مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في قضية صدام حسين، الذي أمر الرئيس بوش “الأب”، بعدم المساس به أثناء الحرب “أعلن هذا قائد القوات الأمريكية في حرب الخليج بعد انتهاء الحرب وكلفه الإعلان منصبه العسكري والسياسي”، ثم صار الرؤساء الأمريكيون يستخدمون صدام، ويشنون الهجمات العسكرية على العراق كلما حان موسم انتخابات يحتاجون فيه لإظهار انشغالهم بمحاربة أعداء أمريكا الخارجيين، بما فيها هجمة متوقعة على العراق خلال الأشهر القادمة مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2002.
الأمر نفسه ينطبق على أسامة بن لادن، والذي يمثل بالنسبة لأمريكا “مسمار جحا” في كل من مناطق شمال وشرق آسيا التي حلمت أمريكا طويلا بغرز قواعد استراتيجية لها هناك، وفي العالم الإسلامي الذي يمكن الإدعاء بوجود امتداد لـ”بن لادن” فيه ما دام هناك أي شخص عربي قاتل في أفغانستان يوما ما.
لو صحت هذه النظرية، فلك أن تتخيل هذا السيناريو قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2008: معلومات استخبارية أمريكية تؤكد وجود أسامة بن لادن، في منطقة ما بدولة “منغوليا” حيث يشتبه أنه يخطط لإعادة إحياء “القاعدة” الأمر الذي اقتضى توجيه ضربة عسكرية للمنزل الصغير المهجور القابع في صحراء منغوليا!!
«ربيعة الرأي».. طالب منازل!
في زمن المجد، كان الذكي من الطلاب يجتاز مراحل العلم ويحفظ المتون ويتقن فنون العلم في سن صغيرة، فلا يبلغ العشرينات من عمره إلا صار من العلماء والمحدثين من تشرأب الأعناق للأخد عنهم، ونماذج هذا كثيرة جدا في تاريخ سلفنا الصالح، ومنهم الإمام ربيعة الرأي الذي بدأ يحدث الناس في المسجد النبوي وهو في أول سنوات عمره بعد البلوغ.
في زمننا هذا، أصبح “الذكاء الزائد” مستحيلا، والسبب أن أكبر عباقرة العرب لا يمكنه أن ينجح للصف الرابع الابتدائي إلا بعد أن يجلس لسنة كاملة في الصف الثالث الابتدائي ويعاشر أطفال الصف الثالث لسنة كاملة ويتحمل محدودية المناهج لسنة كاملة حتى تأتي الاختبارات وينجح، وهكذا لا تمر السنوات حتى أصبح مستوى عقل الطالب مثل عقل زملائه، يزيد عنهم ما يكفيه للتفوق عليهم والهروب من أذاهم، وربما كان هذا السبب عدم وجود نماذج العلماء الشباب في حياتنا المعاصرة إلا ما ندر.
ربما كان الحل لهذه المشكلة أسلوب التعليم الذي بدأ ينتشر في مختلف أنحاء العالم سواء كان ذلك في اليابان أو أمريكا أو أوروبا أو غيرها، وهو “التعليم المنزلي”.
بينما ينظر الآباء والمعلمون لدينا أن تعليم المنازل هو للمتخلفين والضعاف والفقراء فإنه في العالم المتقدم أصبح للأذكياء والعباقرة ومن يريد أهاليهم تنشئتهم تنشئة علمية خاصة.
حتى نستفيد من فوائد التعليم المنزلي دون الوقوع في سلبياته فلا بد من برنامج اجتماعي كامل يشرح للآباء كيفية رعاية طلاب المنازل علميا، وبرنامج مدرسي كامل لمساعدة طلاب المنازل على الاستفادة القصوى من الجلوس في المنزل واستهلاك المناهج، ونظام اختبارات يسمح للطالب أن يتقدم بسرعة في مراحل التعليم الدراسي، وحملات إعلامية تحسن من صورة طالب المنازل، ومواقع إنترنت وتكنولوجيا ووسائل تعليمية مصممة خصيصا لطلبة المنازل، ونظام مقنن للدروس الخصوصية، وآباء يحلمون بأبناء نابغين، وأطفال لا يخجلون من الطموح.
اليابان تفخر بأن واحدا من كل 12 من طلابها “نابغة” وهؤلاء معظمهم طلاب “منازل” ويدخلون الجامعة في عمر الثالثة أو الرابعة عشرة من عمرهم، بينما في أمريكا هناك 850 ألف طالب منازل حسب دراسة أخيرة لوزارة التعليم الأمريكية، وفي الشهر الماضي قدم في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يسمح لطلاب المنازل بالمشاركة في الأنشطة اللامنهجية للمدرسة حتى لا يتسبب أسلوب تعليمهم في عزلة الطلاب عن الجو الاجتماعي العام.
لدينا آلاف النوابغ، ولدينا الحاجة الماسة لمشاركتهم في بناء المجتمع، لكن مدارسنا أصدرت قرارا قديما بمنع “النبوغ الزائد عن حده”.
هل من حقنا الحلم بـCNN عربية؟
في أزمة “الإرهاب” الأخيرة، ظهر سؤال واحد قوي تردد في مجالس النخبة، وصار علامة على صدمة قاسية أصابت الناس في العالم العربي: لماذا فهمنا العالم خطأً؟
أو بالأحرى، لماذا ينظر إلينا العالم كله على أننا إرهابيين مجرمين كارهين لأمريكا، والإعلام الغربي على أننا سفاحون وقتلة، بينما نحن في منتهى المسالمة والهدوء والإعجاب بكل ما هو غربي؟
الجواب جاء على شكل سؤال آخر: ما الذي يمكن أن نفعله على الصعيد الإعلامي لنوصل رسالتنا للغرب؟
وجاء الجواب في قمة أخيرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقرار تأسيس محطة تلفزيونية إسلامية “هذه رابع مرة يصدر فيها القرار دون أن يجد مكانه للتنفيذ، وأرفف منظمة المؤتمر الإسلامي المليئة بالدراسات الصادرة والواردة تشير إلى مصير القرار بنسخته الرابعة”، كما بدأ بعض الناس يدرسون مشاريع إعلامية دولية مثل تأسيس موقع إنترنت باللغة الإنجليزية عن الإسلام، وآخرون يدرسون فكرة إنتاج برامج تلفزيونية، ومجلة إسلامية باللغة الإنجليزية والفرنسية، وأعلن رجال أعمال سعوديون أنهم يعملون على تأسيس قنوات فضائية بمختلف اللغات بحلول عام 2010.
لكن استعراضا سريعا لتجارب الإعلام الدولي السابقة يؤكد عدة حقائق تغيب عن البال:
- الأولى: الإعلام الوحيد الذي نجح في اقتحام أسوار العالم لم يكن الإعلام الياباني أو الألماني “رغم قوة هذه الدول وتميزها”، بل الإعلام الأمريكي وحده هو الذي تفوق في التأثير وإيصال الرسالة الأمريكية لكل شبر على وجه الأرض، ولهذا أسبابه، منها قوة الاقتصاد الأمريكي الذي يسمح للأمريكيين بالتحرك بكل شكل يرغبون فيه، ووجود الدراسات الاستثمارية الأمريكية الناجحة، وقوة كلاسيكيات الإعلام لدى الأمريكيين، والاعتماد على النجاح في الجوانب الترفيهية والدرامية، وأخيرا لأن العالم كله مفتون بالحلم الأمريكي ويبحث عنه ويستمتع به.
- الثاني: وسائل الإعلام غير الأمريكية التي استطاعت التأثير في العالم اعتمدت في ذلك على عمل إعلامي محترف ومخطط له بنجاح، وقناة مثل BBC لم تنجح إلا لأنها سيدة وسائل العالم في أصول المهنة الإعلامية، ولم تنجح الجزيرة إلا لأن موظفيها كانوا يوما موظفين في BBC قبل أن تستقطبهم الدوحة.
نحن في العالم العربي لدينا مجتمع وثقافة مليئة بالتخلف والمشكلات والضعف الذي ينعاه أصحابه قبل أعدائه، ولدينا إعلام بعيد تماما عن الأصول المهنية ويجيد التطبيل بأنواعه ويحب الرقص بأنواعه أكثر من أي شيئ آخر.
كيف يمكننا الوصول للعالم إذا كانت الصورة الحقيقية عن العرب في منتهى الرداءة، وكنا ضعيفين إعلاميا حتى مقارنة حتى ببعض دول العالم النامية؟
هذه ليست دعوة للتوقف، بل هناك الكثير من الجهود التي يمكن أن تبذل على كل الأصعدة للوصول برسالتنا للغرب وتحسين الصورة، ولكنها دعوة للنظر لواقعنا العام ولواقعنا الإعلامي في محاولة لإزالة الغبار عن الصورة.
من هنا تأتي خطوة تأسيس “الجمعية السعودية لعلوم الاتصال”، والتي كانت بمبادرة من الدكتور عبدالرحمن العناد، عضو مجلس الشورى.
هذه المؤسسة خطوة أولى على طريق طويل لتأسيس المعايير المهنية للعمل الإعلامي السعودي والعربي ومراقبة تطبيقها ومنع الصحفيين العرب “المحترفين” والمميزين من الانقراض.
لا علاقة للحجاب بـ«العقد النفسية»
شهد الشهر الماضي في جنوب أفريقيا قضية من أشنع القضايا دلالة على انحطاط الإنسانية وهي قضية اغتصاب عدد من الشباب المراهق لطفلة عمرها عدة أشهر.
وقصص الاغتصاب والممارسات الجنسية البشعة تكثر بنسب عالية في العالم “المتحرر” وتقل في العالم العربي حتى تصل إلى نسب بسيطة في الدول العربية المحافظة مثل المملكة وغيرها.
هذه النتيجة الواضحة للعيان خير دليل أن ما يتوارده الناس من أن الحجاب والمنع الكامل للاختلاط ومنع كل صور الاستمتاع المحرم بالمرأة يسبب العقد النفسية ويزيد من “نهم” الشباب ولا يهدأ من روعهم مستدلين على ذلك بحوادث فردية هنا وهناك، ومؤكدين أننا لم نفهم الإسلام الصحيح ولم نحسن تطبيقه.
لكن الحقيقة أن الانفتاح والحرية الاجتماعية وحصول الإنسان على كل ما يريد سببت مشاكل أكثر وأشنع ولم تحل المشكلة، ويبقى شرع الله تعالى _ بتفسيرنا الشائع له _ خير مسلك لحل المشاكل الاجتماعية على اختلافها.
ربما كانت المشكلة في عدم وضوح أثر منع الاختلاط وتقرير الحجاب في المجتمعات المحافظة _ حسب ما يقول المفكر الإسلامي محمد قطب _ هي نقص التربية واهتمامنا بالظواهر دون التركيز على الأعماق والقناعات والإسلام لا يقوم إلا بمزاوجة تطبيق الشرع مع حب الشرع وكره الهوى.
من يروي لنا حكاية الإنسان الأفغاني المحترق؟
حكايات الكاتب الصحفي المعروف فهمي هويدي، عن أفغانستان والتي بدأ بنشرها على حلقات في جريدة الشرق الأوسط في 22 ذو القعدة الماضي كلها ألم وحزن.
حين تقرأ، لك أن تبكي دما كلما شئت على أفغانستان، البلد الإسلامي الذي كان قبل 15 سنة فقط “حلما إسلاميا” جماهيريا، والبلد الذي أدخل مصطلح “الجهاد” إلى القاموس اللغوي العالمي.
تبكي على أفغانستان حين تقرأ عن النساء والأطفال المشردين بلا مأوى في الشتاء القارس، عن المرضى وكبار السن الذين يموتون الواحد بعد الآخر، عن الصراعات السياسية المقرفة والأنانية التي جعلت من كابول عاصمة الأشباح، عن الشعب الذي لا يجد لقمة عيشه فضلا عن التفكير في مستقبله أو بناء بلده.
كنا بحاجة حقيقية لمعرفة الكثير من التفاصيل عن الحياة في أفغانستان بعد انتهاء الحرب، الحياة في البلد الذي دمره أبناؤه ودمره أعداؤه ودمره أصدقاؤه أيضا. وجاءت رحلة فهمي هويدي كواحد من إبداعاته الصحفية التي تثبت تميزه المهني دائما لتنقل لنا بعض هذه التفاصيل.
بكل أسف، تقتصر التقارير الصحفية التي ينشرها المراسلون العرب “المحترمون” في أفغانستان على تحركات “قرضاي” وحكومته “الموقرة”، وعلى تحركات الجيش الأمريكي، بينما أحد لا يلتفت للإنسان الأفغاني الذي يحترق بالنار ليل نهار.
في الحقيقة هذا هو نمط الصحافة العربية عموما من حيث التركيز على أخبار وتحركات المؤسسات الرسمية متناسية الإنسان نفسه الذي تدور حوله الأحداث.
نحتاج دائما لرحلات صحفية يقوم بها كتاب مبدعون وصحفيون محترفون ومفكرون وأكاديميون ومثقفون يستطلعون من خلالها حكايات الإنسان المسلم حول العالم، يروون لنا الحزن والفرح _ إن وجد _ ويصفون لنا أبواب البيوت المهشمة والأطفال الجائعون بلا ثياب، والشباب ممزقو الأحلام.
لو جاء مؤرخ بعد 20 سنة ليكتب تاريخ المأساة الأفغانية وغيرها من مآسينا التي تتكاثر يوما بعد يوم لما وجد إلا التصريحات الرسمية وتحركات الوفود ولقاءات الشخصيات السياسية وعقود الشركات وضحكات صناع القرار.
نحتاج لحركة ثقافية جماعية تكتب حاضرنا برؤية الإنسان ومعاناة الإنسان وفرح الإنسان أيضا.
المثقفون العرب يدعون لمساواة الكتب بالخيار والبطاطا
سوسن الأبطح، والتي تكتب عمودا صحفيا بجريدة الشرق الأوسط، أعلنت ضم صوتها إلى صوت الناشرين العرب في الدعوة إلى “المساواة الكاملة” لحقوق الكتب مع حقوق الخيار والبطاطا في العالم العربي.
وجاءت دعوة الناشرين العرب هذه بعد أن رأوا المعاملة المدللة للبطاطا في المطارات العربية ورأوا معاملة الاضطهاد التي مرت بها دور النشر العربية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعتبر أكبر تظاهرة عربية للكتاب.
والاضهاد الذي يتحدث عنه هؤلاء الناشرون لا يتناول ما تعودوا عليه من إجراءات الفسح والتقييم للكتب، بل إن ما حصل في ميناء دمياط تجاوز ذلك إلى حجز شحنات الكتب الخاصة بـ78 دار نشر عربية طوال فترة العرض، الأمر الذي أدى إلى بقاء أجنحة الكثير من الدور العربية خالية تماما إلا من أصحابها المشغولين بالاتصال بكل من يعرفونه ومن لا يعرفونه أملا في إطلاق الكتب قبل انتهاء فترة المعرض.
ولكن قرار الإطلاق جاء مع غرامة ضريبية عالية جدا على الكتب إضافة إلى دفع أجور التخزين في ميناء دمياط مما زاد في النهاية عن قيمة الكتب نفسها، فترك الناشرون كتبهم في الميناء ورحلوا عائدين إلى بلادهم.
والكاتبة سوسن الأبطح، عبرت عن انزعاج خاص لأن أحدا من المسؤولين العرب في مصر أو في البلاد العربية التي تنتمي إليها الكتب لم يرض بالتدخل لحل المشكلة ونصرة الكتاب ومساعدة الناشرين العرب المساكين، كما أن اتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب المصري بقيا ساكتين تماما وكأن شيئا لم يحصل.
وجاء على نفس المنوال، البروفيسور روي متحدي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، من أصل إيراني، بعد زيارة له لمكتبة جامعة القاهرة والتي وجد فيها وفي نظام الفهرسة الخاص بها “صورة واقعية لمأساة مصر” ودليلا على تخلف الثقافة والتعليم العالي في العالم العربي، مطالبا “وبكل جدية” في مقال نشره في جريدة “واشنطن بوست”، الحكومة الأمريكية التدخل سريعا لحل هذه المشكلة لأن من مصلحة الأمريكيين ألا يكون العالم العربي متخلفا إلى درجة عجزه الكامل عن اللحاق بمقتضيات الحضارة والمدنية المتسارعة.
لكن دعوة المساواة التي وجهتها الأبطح والناشرين وطلبات التدخل الأجنبي التي قدمها البروفيسور نسيت تماما حقيقة هامة وهي أننا نأكل البطاطا ونستفيد منها لكن أحدا لم يوضح لنا ما قيمة الكتب وما فائدتها لـ”شعوب لا تقرأ”؟.. فلتعش البطاطا وليعش الخيار!!
لا مكان للأحداث الجادة على أجندة المصورين العرب
الدعوة للاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي في العمل الصحفي العربي التي وجهها الكاتب الصحفي طارق إبراهيم، نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، عبر صفحة كاملة من صفحات الجريدة تجاوبت مع حقيقة واقعة وأليمة في مسيرة الصحافة العربية مقارنة بمسيرة الصحافة في مختلف دول العالم تقريبا حتى المتخلفة منها.
صحفنا ومجلاتنا العربية ممتلئة بنوعين من الصور: الصور الشخصية الرسمية وصور المؤتمرات والمحاضرات، والصور النسائية الذي يبدو أنه يبذل لها الكثير من الوقت والجهد ويتفرغ لها معظم الصحافيين المحترفين الكبار في العالم العربي!!
أما الصور الجادة القادمة من ميدان الحدث والتي تعبر عن معاناتنا الإنسانية كشعوب عربية ومسلمة على تنوع أشكال هذه المعاناة فهي نادرة تماما، ولا تلقى اهتماما من أي مطبوعة عربية تقريبا.
ولا أدل على ذلك من أن الصحف العربية تعين دائما مراسلين لها في كل مكان بينما ترفض تعيين أي مصورين وتعتمد اعتمادا كاملا على وكالات الصور الأجنبية التي تنقل بالطبع رؤية هذه الوكالات، ويقاس على هذا بالطبع المحطات التلفزيونية.
لقد كانت صورة محمد الدرة، خير سفير للمأساة الفلسطينية، حيث نشرت في معظم صحف العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ورغم أن المصور كان عربيا فهو كان مراسلا لوسيلة إعلامية أوروبية.
من جهة الصحافة العربية، لا يوجد حتى الآن مصور صحفي عربي واحد معين من قبل وسيلة عربية في فلسطين، ناهيك عن مراكز المآسي الأخرى في العالم الإسلامي وناهيك عن وجود مصورين لالتقاط تفاصيل حياتنا اليومية في البلاد العربية الأخرى.
لقد كان انبهار الأديب والروائي الفرنسي الشهير إميل زولا، توفي عام 1902، بالصور شديدا إلى درجة أن ترك الكتابة وتفرغ للتصوير مؤمنا أن الصورة الناجحة تعكس ما لايمكن للكلمة فعله رغم عدم وجود تقنيات التصوير والطباعة الموجودة حاليا.
وبالرغم أن وسائل الإعلام العربية تعرف أن قرائها ينظرون للصور فقط في معظم الأحيان إلا أن مقارنة بسيطة بين أي مجلة عربية ومجلة من “العالم الآخر” ستريك الفرق!!
ولعله من المؤلم أن ترى الصور المستقاة من معاناة العالم العربي والإسلامي تفوز بأفضل جوائز مسابقة “صور الصحافة العالمية”، عمرها 45 عاما، ولكن لن تجد صحفيا عربيا أو مسلما واحدا بين الفائزين.
كانت الصورة الفائزة التي أعلنت خلال الشهر الماضي لمصور دانماركي من مخيمات اللاجئين في أفغانستان لطفل أفغاني استسلم لرحمة الموت في سلام وهدوء والأيدي المشتققة تحمل بكفنه في لحظة اعتيادية في مخيمات كان يموت فيها المئات كل يوم.
كما كانت هناك عدة صور أخرى فائزة من أفغانستان فاز بها فرنسي مراسل لمجلة نيوزويك، وأمريكي مراسل لمجلة تايم، فازت بجوائز التغطيات الصحفية، وفي جائزة الأخبار فاز إيطالي مراسل لمجلة نيوزويك، بصورة تعكس أحداث الجزائر، وفي جائزة “شخصيات في الأخبار” فاز دانماركي مراسل لمجلة رافوستيرن، بصورة لجنازة طفل فلسطيني في رام الله، وفي جائزة “بورتريه” فازت مصورة من جنوب أفريقيا مراسلة لشبكة “مراسلون يدرسون الحياة”، بصورة لطفلة تمضغ علكة في حقل قصب في باكستان.
أما صور “الحياة اليومية” ففاز بها مصور بريطاني مراسل لجريدة نيويورك تايمز، عن صورة لناس في مترو الأنفاق في كوسوفو.
لاحظ أنه لم يكن بين الصور الفائزة أي صور لراقصات أو مغنيات أو ممثلات “في أول الطريق” أو مذيعات تلفزيون أو عارضات أزياء أو شابات جامعيات، وهنا كانت خسارة وسائل الإعلام العربية!!
* نُشر في مجلة المعرفة السعودية.. عدد رقم 82